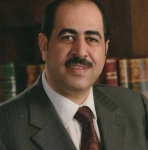مجالس بلا سلطة ، كيف خذلت السياسات المركزية مشروع اللامركزية

تُعد تجربة اللامركزية في الأردن من أبرز التحولات الإدارية والسياسية التي شهدها العقد الأخير، وقد جاءت بهدف تعزيز التنمية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. لكن بعد سنوات من التطبيق، أصبحت التجربة محل تقييم وتساؤل واسع حول مدى فعاليتها، ومدى استعداد الدولة والمجتمع لتطبيقها بصورة حقيقية.
منذ أن بدأت الأردن بتطبيق نظام اللامركزية عام 2017، علّق كثيرون آمالهم على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنمية العادلة للمحافظات، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. لكن وبعد مرور عدة سنوات، تبدو التجربة وكأنها تسير في مسار متعثر، لم تحقق من أهدافها سوى القليل، وهو ما يفتح باب التساؤل حول جدوى التطبيق، وفرص الإصلاح.
تعاني اللامركزية في الأردن من عدة مشكلات جوهرية، أبرزها ضعف الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات، وبقاء القرار التنفيذي مركزيًا في أيدي الوزارات، دون تمكين حقيقي للسلطات المحلية. كما أن غياب التنسيق الواضح بين المجالس المحلية والبلديات، إضافة إلى نقص التمويل المستقل وضعف الكفاءات، قد فاقم من أزمة الفاعلية في الأداء.
إحدى العقبات التي أثرت سلبًا على التجربة هي قصور قانون الانتخاب الخاص بمجالس المحافظات، والذي لم يُصمم بطريقة تتيح للكفاءات المحلية وأصحاب الخبرة الحقيقية الوصول إلى مواقع صنع القرار. إذ طغت على الانتخابات الحسابات العشائرية والاعتبارات الضيقة، ما أضعف التمثيل النوعي داخل المجالس، وأدى إلى غياب الرؤية التنموية المتكاملة في كثير من الأحيان.
يضاف إلى ذلك حالة من العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات، ما يعكس فقدان الثقة في قدرة هذه المجالس على إحداث تغيير ملموس. ورغم هذه التحديات، لا يمكن إنكار بعض الإيجابيات التي رافقت التجربة، وعلى رأسها فتح النقاش حول الاحتياجات التنموية الحقيقية للمحافظات، وإتاحة فرصة، ولو محدودة، لأبناء المناطق في التعبير عن مطالبهم.
لكن النجاح الحقيقي يتطلب ما هو أكثر من ذلك؛ يحتاج إلى إصلاحات جوهرية تشمل كافة جوانب المشروع. أولى خطوات الإصلاح تبدأ بمنح المجالس المحلية صلاحيات تنفيذية حقيقية، تجعلها قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، لا أن تبقى مجرد أجسام استشارية لا وزن فعلي لها. كما يجب تمكين هذه المجالس ماليًا من خلال موازنات مستقلة واضحة، تتيح لها تنفيذ مشاريع تنموية تلبي أولويات المجتمعات المحلية.
وإلى جانب التمكين، لا بد من الاستثمار في بناء القدرات البشرية، عبر تنظيم برامج تدريب متخصصة، وتشجيع مشاركة الكفاءات والخبرات في العمل المحلي. كما أن رفع الوعي المجتمعي بثقافة المشاركة، وتمكين آليات الرقابة الفعالة من قبل ديوان المحاسبة والمجتمع المدني، يمثلان ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح حقيقي.
كل ذلك يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني الناظم للامركزية، وبخاصة قانون الانتخاب، بما يضمن تمثيلاً نوعياً، ووضوحاً في الصلاحيات، وربط الجهود المحلية بالخطط التنموية الوطنية بصورة أكثر انسجامًا.
لقد تعثرت تجربة اللامركزية في الأردن حتى الآن، لكن الأمل لا يزال قائماً بتحويل هذا التعثر إلى فرصة للمراجعة والتصحيح. ما تحتاجه البلاد هو انتقال حقيقي نحو نمط جديد من الحكم المحلي، قائم على الشفافية، والكفاءة، والشراكة، والتنمية المستدامة. حينها فقط، يمكن للامركزية أن تصبح قصة نجاح وطنية، لا مجرد تجربة إدارية ناقصة.