في الكتابة والهجنة
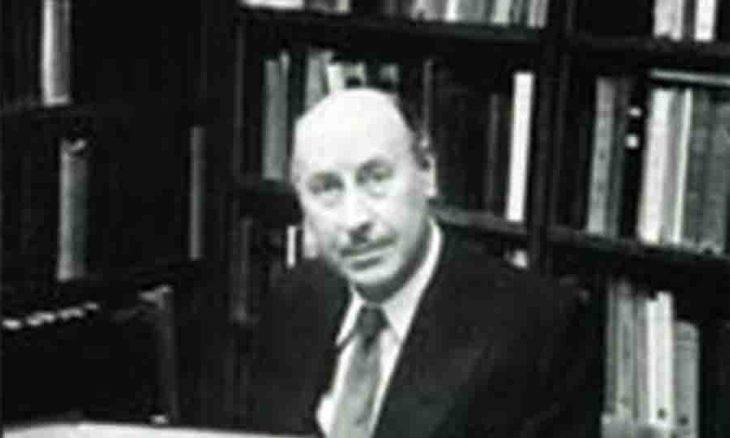
تكاد «الهجنة» في عالم اليوم تحفّنا في كلّ مسالك العيش، فمن السيارات الهجينة التي تجمع بين محرّك بنزين ومحرّك كهربائي، والكمبيوترات اللوحيّة والحواسيب المحمولة، والساعات الذكيّة، والمصابيح التي تضيء بواسطة الكهرباء والطاقة الشمسيّة معا، والهندسة المعماريّة، والفنون الهجينة، والأثاث الهجين مثل الكنبة التي يمكن أن تتّخذ طاولة أو سريرا.. وأدوات المطبخ التي تتعدّد وظائفها.. ناهيك عن الأنواع الأدبيّة مثل «الرواية التوثيقيّة» و«الريبورتاج الأدبي» و«الرواية المصوّرة» أو «غرافيك» أو»رواية الترسّل» التي مدارها على تبادل رسائل، أو «الرواية الفيلم» أو «الأدب الرقمي»، أو «رواية الهجنة اللغويّة» المكتوبة بأكثر من لغة؛ أو «الرواية الموسوعيّة»… وهذا المصطلح «هجنة» هو باختزال مخلّ لا ريب، «تواضع جمعيّ» ومفهوم تاريخيّ، وهو يرتبط في الغرب عند الذين يرتّبون هذه الظواهر ترتيبا زمنيّا، بالفنّ المعاصر، وتحديدا بأعمال الفنّانين التشكيليّين التي أُنتِجتْ بعد 1945؛ وهي تختلف عن حركة الفنّ الحديث (1860-1945). وهذه مسألة «خلافيّة»، فليس ثمّة إجماع على الحدود الزمنيّة الفاصلة من جهة، وعلى «القيمة الفنّيّة» للأعمال التي تنتمي إلى هذه الحركة أو تلك، من جهة أخرى؛ فقد ينتج الفنّان المعاصر أثرا فنّيّا «هجينا»، لكنّه لا يُدرج في سياق هذه الحركة الفنيّة أو تلك؛ أي لا يصنّف، وقد يعتبر «كلاسيكيّا» أو «غير طليعيّ» أو «غير هجين»؛ ما دامت «الهجنة» من المعاصرة التي تعني «التزامن» أو «المعيّة» و«الطريقة الفنّيّة» الجارية أو المتواضع عليها. فلا بدّ من مراعاة «الخاصّ الجمالي» في تقدير العمل الفنّي المعاصر. أمّا في آدابنا نحن، فالأمر أشدّ عنتا، إذ نحن ننطلق في حدّ الحداثة من «الشعر»، وتحديدا من المركزين الكبيرين اللذين نشأت بهما هذه الآداب منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى الثلث الأول من القرن العشرين وهما: بلاد الشام الكبرى بما فيها لبنان وفلسطين، ومصر. وقد جرت النشأة في سياق شّد وجذب بين أنصار القديم من خرّيجي المعاهد والمدارس الدينيّة، وأنصار الجديد أو التحديث من خرّيجي الجامعات الأوروبيّة. وقد يحسن أن نتمثّل بالدور الذي نهض بها المهاجرون السوريّون في أمريكا والبرازيل، في إنشاء الجمعياّت الأدبيّة والصحف العربيّة.
ويسوّغ المستعرب هاملتون جيب ريادة السوريّين المسلمين والمسيحيّين الذين نهضوا بحركة التحرّر الثقافي والأدبي، منذ العقود الأخيرة؛ بما تعلّموه منذ البداية على أسس غربيّة سليمة، بعبارته، وما حصّلوه من معرفة عميقة بالآداب العربيّة القديمة، وامتلاكهم ناصية اللغتين: العربيّة والفرنسية، والعربيّة.
لأقل إذن دون استطراد إلى الاستعمالات القديمة من قبيل: هجنة الكلام أي ما يعيب أو أنّ الهجين هو العربي ابن الأمة ما لم تُحصّن؛ أو الهجان من الإبل وهي البيض الكرام، إنّ «الهجنة» من حيث هي علامة لغويّة مخصوصة (تقنية أو علميّة) إنّما مدارها على تسمية تشير إلى مفهوم بعينه، هو عمل الفكر، أو هي وَحدة فكريّة منظّمة ندرك العالم بواسطتها؛ قد تكون خير ما نمهّد به لكل موضوع أو مسألة خلافيّة كالتي نحن بها، أي هذه «الكتابة الهجينة»؛ وهي تتّسع اليوم للفنون والآداب جميعها. وليكن الشعر العربي المعاصر مثالا، فهو اليوم من التعدّد والوفرة والغنى و«الهجنة»، حتى لَيَحارَ الناقد أو الباحث أو القارئ في تصنيف نصوصه، وأيّها ينتقي أو يتخيّر، وأيّها يترك؛ وبخاصّة إذا كانت جميعها تستجيب للمسألة المطروحة. وقد لا يملك الواحد منّا سوى عيار الشعر القديم: «أشعرُ الناس من أنت في شعره حتّى تفرغ منه»، وهو قول مجهول النسب؛ أورده ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»، وواضح من صيغة التعجّب التي قدّم بها «ولله درّ القائل» أنّه يرضى بهذا العيار ويسوّغه. ولعلّه من وضعه، إذ يصعب أن يكون قول «ذكيّ» كهذا هو أشبه بـ«تقيّة»، متّهم الأصل، غير معروف عند ابن قتيبة. لكن دون صيغة تفضيل هذا على ذاك؛ بل إنّ هذا القول نفسه يجعل كلّ شاعر هو «الأشعر» مادام القارئ في نصّه لم يبرحه. وقد يكون بيننا وبين هؤلاء الشعراء، ما يسمّى «حجاب المعاصرة» الذي يملي علينا حدوده، ويلزمنا متطلّباته، ويجعلنا نتريّث في استصدار أيّ حكم؛ إذ ما دام هؤلاء يكتبون الشعر، فالنصّ مرجأ أبدا، والحكم النقدي ناقص ضرورة. ونعرف من الدراسات الحديثة أنّ ما يفصل بين المؤلّف والقارئ إذا كانا متعاصرين، قد يحجب الرؤية، وقد يجعل القراءة أكثر عنتا عند استقبال النصّ. وهي صعوبة بالغة لا يمكن تذليلها، إلاّ إذا عرف القارئ كيف يستأنس بالنصّ سياقا ومراجع جغرافيّة أو ثقافيّة أو تاريخيّة وأدبيّة وفنّيّة؛ وبخاصّة في موضوع كالذي أنا به. وهذه «مرجعيّات» لا غنى عنها، إذ من شأنها أن تحمي القراءة من شطط التأويل الذي لا سند له من النصّ، وأن تمهّد لها طريقين: النصّ/الشاعر والنصّ/القارئ، آخذين بالاعتبار جملة من «المصادرات» في قراءة أوجه «الهجنة» بين الأجناس، ومدى اختلافها وائتلافها في القصيدة الواحدة التي يتعهّد بعضها نظامًا داخليًا خاصّا، ويستدعي السرد أو الحجاج أو الرسم أو المسرح بل السينما، والفيسبوك… حيث اللغة الشعريّة منشدّة في شعر اليوم، إلى بيئتها بسبب وأكثر، مثلما هي منشدّة إلى عالم رموز وعلامات ومراجع خاصّة بها وبصاحبها، محكومة بمنطق نصّيّ داخليّ؛ وهي تستدعي تجاوبا أو تراسلا «أجسامًا غريبة لها وجود نصيّ مستقلّ»؛ وهذه عبارة لريفاتير، وضعتها بين علامتي تنصيص، وترجمتها بتصرّف بسيط لا يخلّ بها. وهذه «الأجسام» وهي ليست من الشعر، تضفي على النصّ غموضا ما، قد يكون من السهل تبديده في ضوئها؛ إلاّ أن يكون نفقا أسود معتما، لمن لم يرزقوا حظّا من المعرفة أو من الخيال. ولا الإيقاع يفلت من يقظة القارئ، إذا هو رام أن يفكّك هجنة النصّ، ولا التركيب النحوي سواء التزم فيه الشاعر القاعدة، أو هو حرَفها وعدل عنها؛ ولا علامات الترقيم؛ وبخاصّة عندما تُخْفى أو تختفي من النصّ؛ أو هي تتخلّله لِماما، فقد تكون علامة على «هجنة» إيقاعيّة ما خفيّة، أو على معنى غائب أو هو ملتبس بسبب من الأجناس الأدبيّة والفنّيّة المتجاوبة المتراسلة في النصّ الواحد. ومهما يكن، فالعين القارئة هذه «الكاميرا» التي بها نرصد، إنّما تحاول أن لا تلتقط من النصّ إلاّ ما يتّصل بالموضوع المطروح قربا وبعدا، ومكانا وزمانا؛ في مراوحة بين الشعر وهذه الأجناس التي تتداخل فيه وفي نسيجه. ومن ثمّة فنحن في داخل النصّ آنًا، وفي خارجه آنًا، من أجل فهم هذه «الهجنة» فوصفها فتفسيرها فتأويلها. وقد يتعذّر الفهم في بعضها؛ إلأ إذا سوّغنا المعادلة «البودليريّة» حيث يحلّ الانفعال أو ألتأثّر عند استقبال النصّ، ثمّ يكون الفهم لاحقا، وقد لا يكون أصلا من منظور جماليّ خالص. على أنّ هذه السّمات «الهجينة» أو بعضها يمكن أن تُعزى اليوم في هذه العوالم الافتراضيّة، إلى «لغة العامّة» أو «اللغة المحكية» أو إلى أسباب نطقيّة خالصة؛ أو إلى مؤثّرات اللغات الأجنبيّة، وكانت العربيّة قديما بمنأى عنها، إلاّ ما تعلّق بالأزجال والموشّحات، أو كلمات دخيلة تفد من هنا وهناك، وتتشرّبها اللغة كما الإسفنجة.. ومراعاة هذه الجوانب، هي التي تحمي النصّ من القراءة «الخطيّة»، وتتبّع تسلسله الهرمي، والنصّ «الهجين» كلّ لا يتجزّأ، وليس تمثّلا أو محاكاة للوحة ما مثلا أو لواقع أو حدث ما؛ ولنا بحكم ما يمليه الموضوع والمنطق «السيميائي»، كأنْ ننتقل من العنوان وقد يكون صورة أو تركيبا نحويّا قائما على الحذف أو الإضمار، أو من فاتحة النصّ أو من وسطه أو من خاتمته، أو العكس، عسى أن نكشف المعنى، ومنه ننفذ إلى دلالة «الهجنة»؛ دون أن نكفّ عن السؤال: ما «الأجناس الأدبيّة» المقصودة؟ أهي تلك الأجناس أو «الأنواع» الخمسة التي نقف عليها في دراسات المعاصرين: النوع الشعريّ والنوع السرديّ والنوع المسرحيّ والنوع الحجاجيّ والنوع الترسّليّ؟ وهل هي كلّها «أدبيّة» بالمعنى الذي استتبّ لكلمة «أدب»؟ وهي أسئلة شائكة لا يمكن تحاشيها، عند مقاربة مثل هذه النصوص التي تعنت القارئ عادة، وقد تصرفه عن الشعر. ولعلّه فقد اليوم «جنسه»، إذا ما استأنسنا بالأصل اللاتيني/ اليوناني حيث «الجنس» هو «الأصل» و«الميلاد»، و«العِرق»؛ وهو في علم الأحياء، تقسيم العائلة إلى أنواع لها خصائص مشتركة تسمح بتصنيفها. والمشكل أنّ النصّ الشعري «واحد» أو هو غير قابل للتجزئة إلاّ إجرائيّا أي في مستوى القراءة، أو نوع «اللعب» الذي يأخذ به الشاعر؛ وهو يشرع قصيدته على جنس أدبيّ غير الشعر.
على أنّي لا أجد أفضل من هذا المصطلح «ثنائيّ المسكن» يحوي هذا «النصّ الهجين»؛ إذ مثله مثل نبات تكون أزهاره الأنثويّة على نبتة وأزهاره الذكوريّة على أخرى Dioïque.
منصف الوهايبي
*كاتب من تونس














