التعليم الجامعي بين رسالة العلم ومسرحية التسيّب الأكاديمي
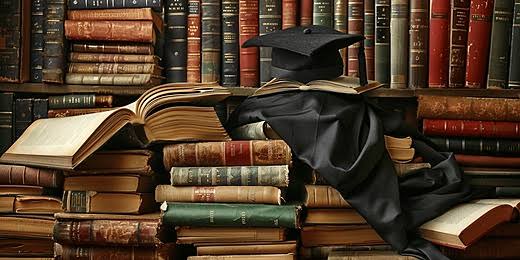
سوزان ابو بكر
في زمنٍ يُفترض أن يكون فيه التعليم الجامعي بوابة الوعي والتنوير وصناعة المستقبل، أصبح في بعض الجامعات مسرحًا للتسيّب الأكاديمي واللامسؤولية، لا من الطلبة فحسب، بل – ويا للأسف – من بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يُفترض أن يكونوا قدوةً ومثالًا في الالتزام والانضباط.
لم يعد غريبًا أن نسمع عن محاضرات تُلغى بلا مبرر، أو عن أساتذة لا يتقنون التفاعل العلمي مع طلبتهم، أو عن تقييماتٍ تُمنح بالمزاج لا بالمعيار. بعضهم يحوّل القاعة الدراسية إلى مساحة استعراضٍ شخصيٍّ أو وسيلةٍ لجمع النقاط في سيرته الأكاديمية، بينما يضيع الطالب بين الرهبة والإحباط واللاجدوى.
هكذا يتحوّل التعليم من رسالةٍ إلى وظيفة، ومن بحثٍ علمي إلى أرقامٍ في السيرة الذاتية، ومن أستاذٍ مربي إلى موظفٍ ينتظر نهاية الدوام.
وما يزيد المشهد قتامةً أن بعض أعضاء هيئة التدريس ما زالوا يعيشون في زمنٍ أكاديميٍ مضى عليه عقود. فهل يُعقل أن أستاذًا تخرّج في الثمانينات أو التسعينات ما زال يُدرّس بعقلية ذلك الزمن، مستخدمًا نفس الأساليب التقليدية دون أن يُحدّث معارفه أو يُواكب تطورات مناهج القرن الحادي والعشرين؟
كيف يمكن لجامعةٍ أن تُخرّج عقولًا جديدة بأساليب عتيقة؟ إن التعليم الجامعي ليس محفوظاتٍ تُلقَّن، بل عملية فكرية متجددة، تحتاج إلى أستاذٍ يتعلم قبل أن يُعلّم، ويواكب قبل أن يُقيّم.
ومن مظاهر التراجع كذلك أن بعض الجامعات ما زالت تُدار بعقودٍ جامعيةٍ حكومية تمتد لعشرين أو خمسٍ وعشرين سنة، فيبقى الأستاذ نفسه والمقرر نفسه والعقلية ذاتها. لا تجديد في المناهج، ولا تطوير في طرق التدريس، وكأن الزمن الجامعي توقف عند عام 2010.
كيف يمكن لمؤسسةٍ أكاديمية أن تُخرّج أجيالاً مؤهلة لعصر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وهي ما تزال تُدرّس بخططٍ ومرجعياتٍ صيغت لعالمٍ كان يعيش بدايات الإنترنت؟
إن الجمود في الخطط الدراسية ليس مجرد تقصيرٍ إداري، بل هو عجزٌ فكريٌّ يُعطّل الإبداع، ويحوّل الجامعة إلى أرشيفٍ علميٍّ بدلاً من أن تكون مصنعًا للأفكار.
ولا يمكن إغفال ظاهرةٍ أخرى باتت مألوفة في بعض القاعات الجامعية، حيث يتحول الأستاذ من معلّمٍ إلى راوٍ لبطولاته الشخصية. فيقضي جزءًا كبيرًا من المحاضرة في الحديث عن إنجازاته وسنوات خدمته ومكانته العلمية، بدلًا من أن يوجه جهده لتبسيط المعلومة وإشراك الطلبة في التفكير والتحليل.
إن الطالب لا يحتاج إلى أستاذٍ يروي له تاريخه، بل إلى من يفتح أمامه أفق المستقبل. فالعظمة الحقيقية للأستاذ لا تُقاس بما يقول عن نفسه، بل بما يزرعه في عقول طلابه من معرفةٍ وحبٍ للعلم.
وفوق ذلك كله، فهل يُعقل أن تكون المحاضرة الجامعية، التي تمتدّ لساعةٍ ونصف، لا يتجاوز فيها وقت التدريس الفعلي سوى ربع ساعة؟ أما الباقي فيضيع في أحاديثٍ جانبيةٍ لا تمتّ للمادة بصلة، أو في سردٍ شخصيٍّ عن تجارب الأستاذ وحياته الأكاديمية.
كيف يمكن لطالبٍ أن يتلقى علمًا حقيقيًا في ظل هذا الهدر الزمني المتكرر؟ إن قاعة المحاضرة ليست مجلسًا للحديث، بل ميدانًا للمعرفة، واحترام وقت الطالب جزءٌ من احترام رسالته العلمية.
إن الطالب لا يأتي إلى الجامعة ترفًا، بل يسعى إليها حاملاً طموحه ومستقبله، ودافعًا من ماله ووقته وجهده ليحصل على تعليمٍ راقٍ يليق بتعبه، لا على محاضراتٍ ناقصةٍ أو أساليبَ تقليديةٍ لا تُنمّي فكره ولا تُعدّه لسوق العمل.
النتيجة الحتمية لهذا التسيّب الأكاديمي هي جيلٌ جامعيٌّ فاقدٌ للشغف، يشعر أن الجهد لا قيمة له، وأن النجاح لا يحتاج إلى تفكيرٍ بل إلى "العلاقات". جيلٌ فقد الإيمان بالعدالة الأكاديمية، وصار يرى أن الجامعة لم تعد مكانًا لتشكيل الفكر، بل لتكرار المقررات.
إن الإصلاح الحقيقي للتعليم الجامعي لا يبدأ ببناء مبانٍ جديدة أو تحديث مختبرات، بل بإعادة بناء ضمير الأكاديمي. فالأستاذ الجامعي هو روح الجامعة، وإذا ضعفت روحه ضاع العلم وضاعت معه الأجيال.
لقد آن الأوان أن نعيد الهيبة للعلم والمعلم، وأن نسأل بشجاعة:
هل ما زالت جامعاتنا تصنع العقول أم تصنع الشهادات؟














